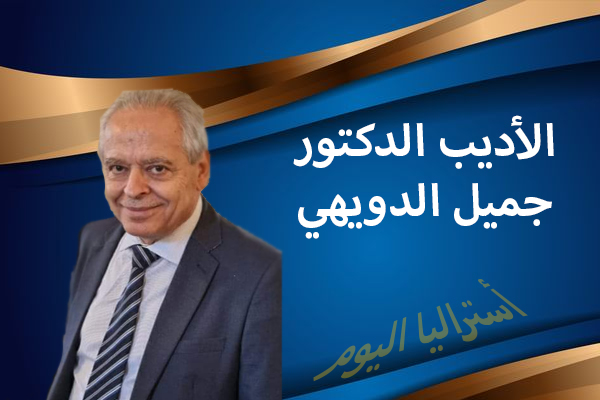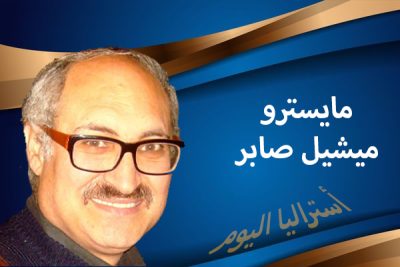بقلم الإعلامية / صبحة بغورة – أستراليا اليوم
بقلم الإعلامية / صبحة بغورة – أستراليا اليوم
تقتضي تطورات الأحداث التي تطٍرأ في العلاقات بين الدول وقت اشتداد الأزمات فيما بينها أن يلجأ أحد أطراف النزاع إلى تصعيد موقفه منها حسب طبيعة ما يستجد فيها من ملابسات، يكون هذا التصعيد في أغلب الأحوال من أجل فرض الحلول التي يراها هي الأفضل، وبديهي أن يسعى هذا الطرف أو ذاك ممن يبصر في نفسه موقف القوة والتفوق أن تكون هذه الحلول بمثابة المرآة الصادقة للحفاظ على مصالحه، والضامن الأكيد للبقاء في موقف القوة، بل وأن تكون صمام الأمن المستقبلي لتجنب عودة نشأة مسببات الأزمة وتفادي تكرارها، وعلى رأس مظاهر هذا التصعيد، إعلان الحرب.
يحدثنا التاريخ أن قرار إعلان الحرب بين الأمم لم يكن يستغرق زمناً، فلا يتجاوز مثلاً مدته حدود بحث كيفية تنفيذه في الميدان، كما لم يكن اتخاذ مثل هذا القرار الخطير بحاجة كبيرة لتوفير أسبابه المقنعة سواء كانت حقيقية أو واهية، وسواء كانت مؤكدة أو محل شك فيها، كما لم يكن اتخاذ القرار يتوخى تلمس حساسية الأوضاع السياسية المحيطة بقدر ما كان الأهم أن يكون العمل العسكري في حد ذاته موفيا لدواعيه كاملة ملحقا أشد الأضرار التي تحقق أهدافه سواء العقابية أو الانتقامية أو الردعية.. أو الاستعمارية، إنه منطق القوة الذي سادت همجيته زمنا وقضى على ملايين البشر.
أبت كل المواثيق الدولية التي صدرت على أنقاض ما قاسته البشرية من ويلات الحرب العالمية الثانية إلا أن تواكب تطور الفكر الإنساني وأن تكون عاكسة لتطلع شعوب العالم نحو بناء حضارة تعترف بحق الأمم في التحرر وتؤكد حق الشعوب في العيش الكريم، وأن توثق هذه الحقوق فتفرض على كافة الأنظمة السياسية احترامها وتجبر كل الحكومات على التمسك بها سلوكاً وفكراً وعقيدة.
اتجهت جهود كل الدول في عصرنا الحديث إلى تطوير قدراتها العسكرية وتجديده وتحديث أسلحتها حتى أصبحت الصناعة العسكرية نشاطاً رئيسياً حيوياً في منظومة النشاط الاقتصادي للكثيرمن الدول الصناعية الكبرى، وأصبحت العودة للسباق نحو التسلح ظاهرة مقلقة تهدد السلام العالمي وتناقض مبدأ نبذ العنف المسلح، والسؤال الحائر هنا، لماذا تجددت النزعة لامتلاك الدول المزيد من عناصر القوة المسلحة؟
ولماذا ازدهرت تجارة السلاح عبر العالم؟
ولماذا تسعى كل الدول إلى امتلاك أسلحة التفوق الاستراتيجية المدمرة؟
الواقع لا يحمل دلائل النية الحسنة، ولا يشير الى المساعي الحميدة، حيث بات الميل إلى التهديد باستعمال القوة أعلى صوت، بل ويسبق الدعوات لترجيح الجهود السلمية واستغلال فضائل الحوار السياسي في تسوية الأزمات.
لا تولد الأزمات الدولية من فراغ، وهي قد تنشب نتيجة مشاكل مستجدة أو بسبب خلافات تاريخية بقيت عالقة زمنا كقنابل موقوتة، والسائد في العلاقات الدولية أن تجنح الدولة التي تستشعر أن حيفا قد أحاط بها أو ظلما قد أصابها إلى إفادة المجتمع الدولي كما هو مفترض بملابسات ما تعرضت له لحشد الرأي العام الدولي إلى جانبها ودعمه لها ضد خصومها وإنصافها لاسترجاع حقها ورفع الظلم عنها، وكثيراً ما تعلن هذه الدولة أنها تحتفظ بحقها “المشروع” للحفاظ على حرمة ترابها وسيادتها وكرامة شعبها بالوسائل الممكنة وفي الوقت الذي تراه مناسبا، إنه تلويح صريح باحتمال استعمال القوة المسلحة وفق مقولة “وقد أعذر من أنذر..” والحاصل أنه على قدر ما يمكن أن تسوقه أي دولة من أسباب أو تقدم ما أمكنها أن تسوغه من مبررات لاستعمال القوة المسلحة فهو لا يكفي لحصولها على تأييد دولي بإعطائها كل الحق في إعلان الحرب لأن الأمر مهما كان يتعلق في النهاية بإراقة الدماء، وعليه فإذا كان المجتمع الدولي من جهة ينبذ العنف ويندد بسفك الدماء، فإنه من جهة أخرى لم يملك إزاء الكثير من القضايا الدولية أدوات الضغط الكافية من خلال الهيئات والمنظمات الدولية التي تمثل إرادته للامتثال لقراراته، بل أن صمت المجتمع الدولي كان دافعا لمضي بعض الأطراف في غيها مستفيدة من صعوبة تحقيق إجماع على إدانتها، وأصبح على عاتق الدولة المطالبة بحق لها أن تزود خطابها السياسي بالمنطق الذي يبرر لجوءها للعمل العسكري ويعززه، وذلك حتى لا تقع تحت طائلة الاستنكار والتجريم أو أن تكون عرضة لعقوبات دولية قد لا تطيق تحمل تبعاتها وهي في أدني مستوى لها، فالمنطق يقتضي أن تفيد الدولة المجتمع الدولي بكل الخطوات التي اتخذتها لحصر الخلاف في أضيق الحدود، وأن تستعرض على المستوى الدولي كل الجهودها التي بذلتها من أجل احتوائه وأن تنشر بيانات بتحركاتها الايجابية في اتجاه الحل السلمي له، وأن تؤكد صحة مواقفها على مستوى علاقاتها الدولية في شكلها الثنائي والمتعدد الأطراف وجعلها رسائل غير مباشرة للخصوم فيكون من المنطقي والمفهوم أنه الأمر نفسه بالنسبة للشركاء السياسيين يضخم بكل منطقية حجم الحلفاء من الدول.
يستمد المنطق السياسي أهميته في الجدل السياسي، كما يستمد قوته من مقدار الواقعية والموضوعية في التناول ومن مدى الحيادية في الموقف والنزاهة في التقدير، وكلها اعتبارات تفترض أن يكون من يحرص على اتباعها أن يكون على علم مسبق ومعرفة واسعة وإلمام كبير بكل جوانب المسألة، وهي إذا اجتمعت فإنها تكسب صاحبها مهارة استغلال المناسبة بجعلها فرصة لاستحضار القيم التي تنفض الغبار عن الحقائق التاريخية التي ربما لا يصمد أمامها كل استنتاج متعجل، فتكون بذلك محل إعجاب بالمسعى وتشجيع للمبادرة ودعوة للاقتداء، إنها ميزة السداد في الرأي وفي إدارة الأزمات بالمنطق الذي يعزز الخيارات بما فيها الخيار العسكري الصعب الذي يناظر في صعوبته مفهوم الرباط الشرطي الخاص باعتماد ثقافة الخوف مثلا بزعم وجود خطر على البلد ومصلحة الوطن تعطي للأمن حق التدخل في السياسة الحكومية، فثمة مواقف هي التاريخ، وثمة مواقف في وجه التاريخ حاضرة، وسياسات تنتج المزيد من المنطق الحضاري وتراعي خصوصيات الأمم وتتحاشى منطق التسوية الحضارية للأزمات، وهناك سياسات تأخذ صفة الشاهد في المأساة، ومن المنطق السياسي الاعتراف بأنه حيث لا توجد إيديولوجيا مسبقة على الواقع، فإنه لا واقع بلا إيديولوجيا، وعليه يمكن أن يخفي الصراع العسكري الظاهر خلافا إيديولوجيا عميقا يحتاج فيه كل طرف إلى ما يعزز مرئيته بمنطق يجعل موقفه أوضح في الحجة وأبين في المنع، إذ يعتبر الموقف بصفة عامة علامة فارقة في الزمن من المفروض بداهة أنها لا تحتكم إلا للمبادئ ، ويبدو أن بين شكل الموقف وطبيعة المبدأ علاقة جدلية واضحة، فعلى قدر سمو ورفعة المبدأ يكون نبل الموقف والعكس صحيح فحقارة الموقف من دناءة المبدأ.. وبين الاعتماد على المبدأ الذي يعبر في حقيقته عن نوع العقيدة من جهة، وبين تجسيد الموقف عمليا بشكل كلي أو جزئي من جهة أخرى تكمن أهمية تحديد لغة الخطاب الذي من المفروض أن يتضمن ما يؤكد أو ينفي أمرا محددا بشأن موقف سابق أو لاحق حول قضية معينة، ويحتاج العمل العسكري إلى تأييد سياسي يكسبه الشرعية ويحشد الدعم الشعبي الضروري حوله ، ويأتي مثل هذا الدور في صلب منطق يبرره ويتم التسويق له في الخطاب السياسي على النحو الذي يعززه، وهنا يثور التساؤل مجددا عن ما مقدار الصحة التي يمكن أن تصيب كبد الحقيقة عندما يتعلق الأمر بالحديث الحائر بين العسكريين عن العلاقة الموجودة بين صرامة لغة المواقف ومناورات لغة السياسة ؟
قد تدفع الظروف المحلية أو الدولية إلى انحراف الخطاب السياسي غصبا أو طوعا عن مقصده النبيل بأن يبتعد عن غايته السامية وذلك إما بالتمويه على الصحيح من الرأي، أو بالتعتيم على عمليات تصفية الحسابات ، أو أن يزيغ مضمونه البصر بالأوهام وتضيع معانيه البصيرة بالآمال الزائفة والوعود الكاذبة من أجل تحقيق أغراض خاصة أو لمراعاة مصالح ضيقة، وحينها نكون في مواجهة معالم نموذج التيه السياسي الذي لا يسمح باختصار لأي كان اقتحام مناطقه المظلمة، وهو نموذج يؤدي حتما إلى وقوع الخطأ في العمل السياسي ويؤدي تبعا لذلك إلى تناسل الأخطاء وإلى الوقوع في دائرة الشك حيث الممكن يصبح فنا يبرر النفاق في الخطاب تماما كما يبرر الإيمان بالموقف فتضيع بذلك بوصلة المنطق السياسي فيحرم العمل العسكري من فضائل تعزيزه .