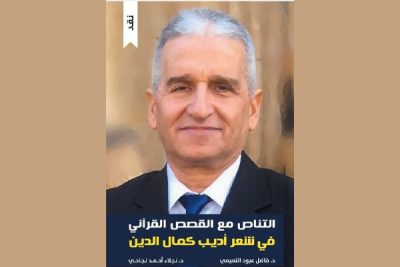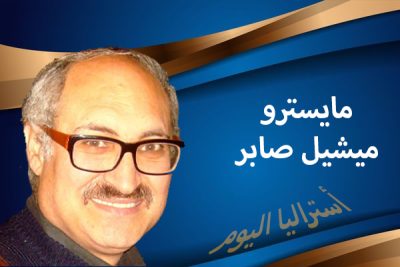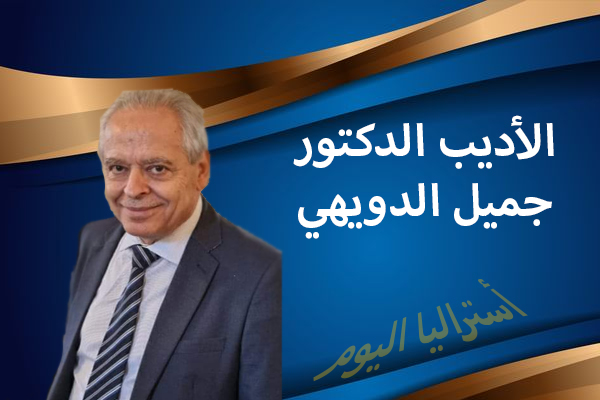الضعف الأخلاقي – مقالات متنوعة
غريغ كرافن – نائب رئيس الجامعة الكاثوليكية الأسترالية ورئيسها من عام 2008 إلى عام 2021.
إن السمة المميزة لأي مجتمع، هي قدرته على التمييز بين الخطأ والصواب.
وبدون ذلك، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد حشد منظم.
ومن بين كل الظواهر الأخلاقية:
- الشر.
- القلب الأسود.
فالمجتمع الذي لا يعرف الشر هو مجتمع فاشل أخلاقياً.
لقد افترضنا منذ فترة طويلة أن الشر واضح بذاته، ويتحدث عن نفسه، ويمكننا أن نشم رائحته حرفياً.
ولكن بالنسبة لأستراليا، فإن هذا الآن مجرد تباهي فارغ.
إن أعذارنا للمذابح التي ارتكبتها حماس، ضد الجانب الإسرائيلي مباشرة، تظهر لنا حقيقتنا.
أمة تستطيع أن تحدق في الشر عارياً ولا تتعرف عليه. أو حتى تبتسم بخجل.
وهذا ليس مجرد عار، بل إنه اتهام وطني بالعجز الأخلاقي.
الشر في هذه الأيام:
ففي هذه الأيام التي تسودها أخلاقيات النقر على الإنترنت وأخلاقيات برامج تلفزيون،
إننا لا نتحدث كثيراً عن الشر، ولهذا السبب يتعين علينا أن نبدأ الآن على وجه السرعة.
لا أحد شرير لمجرد أنه غبي أو جاهل أو عنيد أو حتى مسيئ.
الشر هو الصفة التي تأتي مباشرة في نهاية نطاق واسع من الدناءة المتصورة.
وفي الطرف المقابل هناك مجرد الخلاف، وحتى الخلاف غير المسؤول.
غالباً ما نعتبر أولئك الذين يختلفون معنا ناقصين أخلاقياً.
عادة، هذا غير صحيح. حتى الأغبياء يحق لهم إبداء آرائهم.
الضعف الأخلاقي والخطأ
بعد ذلك يأتي الخطأ. يمكن لأي شخص أن يفعل شيئًا خاطئًا بشكل لا لبس فيه.
عادة، سوف يتصرف بشكل غير أخلاقي أو غير قانوني أو كليهما، لكن هذا لا يضر في الواقع بكيانه أو، كما اعتدنا أن نقول، بروحه.
ثم هناك الشر، وهو مفهوم أكثر كثافة. الشخص أو الفعل السيئ ينطوي على فشل أخلاقي أساسي. شخصية الفرد أو الفعل ملوثة.
هناك أمثلة عملية سهلة. في الاستفتاء الأخير على الأصوات الأصلية، اختلف الكثير من الناس مع بعضهم البعض.
في الغالبية العظمى، لم يكونوا أشخاصاً سيئين، على الرغم من أن البعض على كل جانب كانوا أكثر اطلاعاً من الآخرين.
إن ما هو أسوأ من ذلك هو أن تشويه سمعة شخص ما أو التهرب من الضرائب أو السرقة أو ضرب شخص ما أو ارتكاب الزنا.
وسوف يعاقبك القانون على بعض هذه الأفعال، ولكن ربما ليست الأفعال الصحيحة.
الضعف الأخلاقي والاعتجاءات الجنسية
وعلى المستوى التالي، وهو مستوى أسوأ كثيراً، يتجسد الشر في كل أشكال الاعتداء الجنسي وجرائم القتل.
وينطوي هذا على أفعال شريرة يرتكبها أشخاص أشرار. وهذه الأفعال بغيضة وتستوجب عادة عقوبات قاسية.
ولكن الأمر يتطلب عنصراً من الرعب الشديد والمتتابع لرفع حتى هذه الأنواع من الأفعال إلى الدائرة الداخلية للجحيم المقصود.
وهذا هو الشر.
إذا كنت متديناً، فإنك تقضي قدراً لا بأس به من الوقت في التفكير في الشر. وأحياناً أكثر مما ينبغي.
ولكن عندما يحدث شيء مثل الفظائع التي ارتكبتها حماس، فإنك تحصل على فرصة رهيبة للتحقق من تصوراتك.
الشر يتألف من ثلاثة عناصر:
- أولاً، الفعل نفسه خاطئ بشكل عميق وواضح. وهذا اختبار موضوعي.
– على سبيل المثال، الاعتداء المميت خاطئ بشكل لا لبس فيه.
- ثانياً، يجب أن يفهم الجاني الخطأ المطلق لأفعاله من حيث العواقب.
– إن المعتدي الجنسي يعرف تماماً كم سيعاني الضحايا وأسرهم.
- ثالثاً، الحاسم هو الذي يبعث على الرعب حقاً. فالشر لا يحدث فجأة، بل إنه يتلذذ به. ويحتفل بأهواله. ويتباهى بألمه.
– إن الشر، وليس القوة، هو المنشط الجنسي النهائي.
وليس من المستغرب أن يندد العرابون في سر المعمودية الكاثوليكي ليس بالشيطان فحسب، بل وأيضاً “بسحر الشر”.
إن الشر الحقيقي جذاب وبراق، ويشكل متعة هائلة لمن كرسوا أنفسهم له.
الإبادات التاريخية:
فكّروا في أدولف هتلر، وهاينريش هيملر، وجوزيف جوبلز، وإبادتهم.
لم تكن مذبحة العرق مجرد واجب قاتم. بل كانت شيئاً يستحق الاحتفال، وموضوعاً للتفاخر وحتى للسخرية.
لقد رقص النازيون حول نيران المحرقة. وعلى نحو مماثل، كان جوزيف ستالين يتلذذ بقوته في القتل وممارستها أثناء تصفيته للمعارضين الحقيقيين والمتخيلين. كان يتأمل عمليات القتل وتفاصيلها بارتياح وسرور، وأحياناً بنشوة.
تصرفات حماس جرائك ضد الإنسانية
وبهذا المعيار، فإن تصرفات حماس منذ السابع من أكتوبر كانت شراً لا يضاهى.
وهي في المجمل تشكل شكلاً مرعباً من أشكال الإرهاب، ولكن فظائعها تتفوق أيضاً على كل معايير الإجرام الفادح.
ومن الناحية الموضوعية، وبصرف النظر عن أي مبررات، فإن تصرفات حماس خاطئة لا يمكن إصلاحها.
فالقتل، والخطف، والاغتصاب، وتشويه الأعضاء التناسلية، وقطع الرؤوس بوحشية، وذبح الأبرياء، والإذلال العنيف الطقسي، والعذاب العقلي المحطم للعقل ـ ناهيك عن التضحية بشعبك لحماية نفسك ـ كلها جرائم ضد الإنسانية.
وهذا صحيح في أي حرب، حتى الحرب التي يُفترض أنها عادلة.
إن حماس تعرف تماماً العواقب المروعة لأفعالها.
فعندما تقطع رأس شخص ما، فإنك تدرك ما تفعله. وعندما تذبح طفلاً، فإن عينيك لا تنفتحان على موته فحسب، بل على عذاب والديه.
عندما تحرض على الحرب ضد إسرائيل من أجل تعزيز مكانتك وقوتك، فإنك تقصد قتل مواطنيك.
حماس تستغل حياة الناس
فحماس تدرك جيداً الاستغلال الساخر لحياة الناس وأسرهم، والقتل بالوكالة من خلال استخدامهم كدروع بشرية، والتشريد الجماعي.
إن هذا الإنفاق المقصود لأرواح الفلسطينيين لاستخدامها كأوراق مساومة دعائية، في حين تتظاهر بالتقوى بأنها منقذهم، يشكل جزءاً لا يتجزأ من شر حماس.
حيث إن حماس، التي تتسم بالسخرية والازدواجية وعدم الاكتراث التام، تذكرنا بجملة دون ماكلين في فيلم “الفطيرة الأميركية”: “رأيت الشيطان يضحك من شدة البهجة”.
أما عن تلك البهجة، فمن منا يستطيع أن يتجاهل النشوة الشديدة التي انتابت مرتكبي كل هذا الموت واليأس:
الرقص على الجثث، والصيحات المبهجة بالنصر حول الأسر المحطمة، والاستعراض المهين للأسرى.
نغمات حماس المرعبة
ولكن الأسوأ من ذلك هو النغمات المرعبة التي تعبر عن الرضا عن الذات من قِبَل قيادة حماس والمتحدثين باسمها وهم يحددون المطالب والأحكام. لقد ذبحناكم. لقد استحقيتم ذلك. وسوف نستمر في ذلك. “سنبيدكم من النهر إلى البحر أيها اليهود.
وما معنى المزيد من رعاة الحمير الفلسطينيين القتلى على طول الطريق؟ يا له من فخر، مجد ذاتي وفرح قاتم. يا له من شر.
ليس من السهل تحديد مسارات الأحداث بأكملها، في مقابل حلقات أو أفراد معينين، ينافسون هذا الغياب المذبح للإنسانية.
بالتأكيد المحرقة، وربما الإبادة الجماعية للأرمن، ولكن ماذا أيضًا؟
مثل تاريخي حيّ
في تاريخ عائلتي، هناك مجاعة البطاطس. لا شك أن هناك سياسيين وملّاك أراضي إنجليز رأوا الفرصة “لتقليص” السكان، وكان هؤلاء الأفراد أشرارًا.
ولكن حتى في ذروة غضبي، لا أستطيع أن أصدق أن السياسة البريطانية كانت تنوي قتل الأيرلنديين جماعيًا.
الإهمال الإجرامي، نعم. القتل الجماعي المتعمد مثل حماس، لا محالة.
الخوف من قول الحق
ومع ذلك، في مواجهة الفظائع المنهجية التي تمثلها حماس، لا يستطيع بعض الأستراليين ــ وخاصة من اليسار ــ نطق كلمة الشر.
بل قالوا بدلاً من ذلك:
- الإسرائيليون هم الذين استولوا على الأراضي الفلسطينية.
- دولة إسرائيل غير شرعية تاريخياً.
- اليهود يقصفون غزة ويقتلون المدنيين. وهي لا يلتزمون بالقانون الدولي.
ومن هنا تأتي أهمية تجنب كلمة “إرهاب”. فمن الممكن تبرير الكثير من الأمور بالاتهامات المضادة والمراوغات.
ولكن لا يمكن تبرير الشر الصريح.
جزءٌ من هذا اللامبالاة اليسارية يرتكز على واقع مرعب.
إن جرائم القتل والاغتصاب التي يرتكبها المتطرفون المحترفون ليست مجرد هجوم على إسرائيل.
بل هو هجوم على الغرب وكل ما يتبناه من تسامح ولباقة وتحضر.
تل أبيب هي الوكيل العالمي
فمن المؤكد أن تل أبيب هي وكيل لندن وباريس وسيدني.
ولأن هؤلاء المتطرفين يكرهون من حيث المبدأ الثقافة الغربية التي تتألف من الرأسماليين والمحافظين والمحسوبية.
فإنهم يتفاوضون مع الوحوش التي تشن حرباً ضد المجتمع الذي يحمي حقهم في الاختلاف.
تلك الوحوش التي تسعى إلى القضاء عليهم في أول فرصة.
إن هذا هو السبب الذي يجعلنا لا ينبغي لنا أن نتحدث ببساطة عن تعرض إسرائيل للهجوم، أو خوضها حرباً، أو اتخاذها قرارات صعبة.
ففي هذا النوع من الهجوم الثقافي بالقنابل القذرة على القيم الغربية، لا وجود لإسرائيل.
بل نحن فقط أعظم منها. وفيما يتصل بحماس وحلفائها، فإننا جميعاً نرتدي الكيباه الآن.
فالسبب الدقيق وراء إلغاءنا لمفهوم الشر في الغرب معقد.
فروقات دقيقة بين اليهودية والمسيحية
ربما يتعلق الأمر بانحدار الدين.
فبالرغم من كل الفروق الدقيقة التي تتسم بها المسيحية واليهودية ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ فإنهما تتمتعان بالثقة الأخلاقية اللازمة لوصم الخطأ الفادح.
ولعل القواعد الأخلاقية الحديثة جيدة فيما يتصل بسلوك الأطفال في الملاعب والمحاسبة، ولكنها ليست جيدة فيما يتصل بالإرهاب.
وقد يرجع السبب إلى تراجع قبول تجسيد الشر.
فإذا كنت تؤمن بالشيطان، فسوف تكره أدواته. وإذا حددتها، فسوف تجد الشر.
دور التفسير النفسي
من المؤكد أن عالمية التفسير النفسي تلعب دوراً في هذا السياق.
فنحن نبرر الأشخاص السيئين من خلال تربيتهم وأمراضهم العقلية.
بل نستطيع حتى أن نصنف كل عمل شرير باعتباره مجرد عرض آخر من أعراض الاعتلال النفسي المؤسف.
ولكن أي شخص يعتقد أن هتلر وحماس مجرد فشل في التطهير النفسي يحتاج إلى العلاج.
بل ومن الواضح أن النسبية الأخلاقية وما بعد الحداثة تلعبان دوراً في هذا.
فإذا لم يكن هناك شيء اسمه الحقيقة، فلا يوجد شيء اسمه الشر.
إدراك الصواب والخطأ
ومن ناحية أخرى، كان الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو يؤمن بالصواب والخطأ، بشرط أن يكون هو الحكم الوحيد.
من المؤكد أن الطريقة التي يتصور بها الأستراليون الصواب والخطأ قد تغيرت.
تاريخياً، كنا نركز على رذائل محددة نسبياً يمكن التعرف على نتائجها بسهولة.
كنا نعارض بشكل خاص الشرور الواضحة مثل العنف والخداع، وعواقبها مثل الاحتيال والسرقة والقتل.
حتى أن شيئاً مثل الحرب العالمية الثانية كان له تركيز مباشر: هزيمة الفاشية، والإطاحة بأنظمتها وتدمير إيديولوجيتها القذرة للغاية.
والآن نتعامل مع مفاهيم أكثر غموضاً للخطأ، مع علامات أقل وضوحاً وتأثيرات أبعد.
التفاهة المجتمعية
ربما يكون السبب الأخير هو التفاهة المجتمعية.
فهل المجتمع المهووس بوسائل الإعلام الاجتماعية والتعريف اللانهائي للهويات المجهرية لديه أي استخدام حقيقي لمفاهيم عتيقة مثل الشر؟
هل يتمتع بوجود X؟
لماذا يطارد الشر اليهود
وبطبيعة الحال، فإن السؤال الكبير الآخر الذي لم تتم الإجابة عليه هو لماذا يطارد الشر اليهود دائماً؟
والإجابة الساخرة السوداء التي قدموها هي أن الأمر ببساطة مسألة تقاليد، مثل الديك الرومي في عيد الميلاد.
نظريات أخرى
يشير المؤرخون الجادون إلى حقائق العصور الوسطى التي روجت لكراهية اليهود، مثل احتكارهم لإقراض المال، وحظر الربا على المسيحيين.
ويزعم آخرون أن عامة الناس يشعرون بالغيرة ببساطة، نظراً للإنجازات الفكرية وغيرها المذهلة التي حققها العديد من اليهود.
ويدعي البعض أن اليهود كانوا دائماً “الآخر”، الغرباء الدائمين في عالم متعصب. وهذا أقرب إلى الحقيقة.
إن التهمة الحقيقية الموجهة إلى اليهود تتلخص في أصالتهم التي لا تغتفر وخلودهم.
حيث إنه قبل كارل ماركس، نابليون بونابرت، يوليوس قيصر، والإسكندر الأكبر، وصولاً إلى الكنيسة الكاثوليكية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، كان اليهود موجودين وما زالوا هنا، عرقاً وديناً وثقافة.
لقد رحل الإغريق والرومان القدماء مع دياناتهم ولغاتهم اليومية، ولكن اليهود فما زالوا موجودين وهو ما يشكل عاراً على ضعفنا.
في نظر وحوش اليمين، يرتكب اليهود الجرائم بسبب اختلافهم المستمر، فهم لا يمتثلوا أبداً لأي عقيدة قومية.
فمن جهة اليسار المتعصب فهم يرونهم مرتكبي الجرائم بسبب الالتزام الثابت بالحقيقة الموروثة.
في الواقع، وباعتبارهم أقدم ثقافة فكرية مستمرة في الغرب، فإن اليهود لا غنى عنهم. إنهم بالمعنى الحقيقي للكلمة سكانه الأصليين الثقافيين.
ومن المفارقات القاسية أنه في الوقت الذي يكافح فيه الغرب السائد للتخلي عن معاداته التاريخية للسامية، فإن اليهود الآن مكروهون من قبل ظواهر الشر مثل حماس.
هم مكروهون ليس فقط لأنهم يحتلون الأراضي أو يخوضون الحروب، بل لأنهم يمثلون ذلك الشيطان الأعظم، الغرب.
لذلك، يجب علينا نحن في الغرب أن نتعرف على النفوس الأخرى عندما نراها.